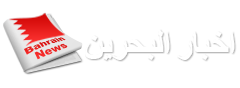إيلاف - 11/28/2025 7:15:18 AM - GMT (+3 )

سهام القحطاني
إن الانتقال من زمن الشفهية إلى زمن الكتابة كان انتقالاً حضارياً من الخطاب إلى النص، انتقال لم يقتصر على تبادل وسائط معرفية، بل رفع الإنسان من التفكير الانفعالي الذي يتسم به الخطاب إلى التفكير العقلي الذي تتسم به النصيّة، انتقال من خصائص الأسلوبية الوجدانية إلى خصائص البنائية الفكرية.
وتفرق نظرية النص وتحليل الخطاب بينهما بأن النص «بنية لغوية ذات وحدة دلالية» في حين أن الخطاب موقف لغوي متعدد الدلالات؛ تتعلق بالسلوكيات اللغوية ومؤشراتها، ومؤثرات» ووفق هذه مرفقات هذه السلوكيات تنشأ تفاعليّة الخطاب مع المتلقي.
والعرب قبل الإسلام لم يعرفوا دلالة الخطاب كما هي في الدراسات الحديثة، بل توصلوا إلى دلالتها بعد الإسلام وتكرار لفظ «الخطاب» في النص القرآني الكريم، وقد فسر الزمخشري مفهوم الخطاب في القرآن «بالكلام المسند بقصدية ودلالة» أما الآمدي فقط فسر الخطاب «باللفظ المتواضع عليه، المقصود به إفهام الناس» أي المألوفيّة والمقصد والدلالة كما ذهب الزمخشري.
ويربط التهانوي الخطاب في كتاب كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، بالأصل الشفهي ويحدد وظيفته بأنه وسيلة تواصل بين المتكلم والسامع.
في الخطاب المنطوق يقوم المتلقي بفرض توجهاته على منتِج الخطاب، وبالتالي فإن المتلقي هو الذي يتحكم في قيمة الخطاب، وهذه المسألة تتضح في»النقد اللغوي» سواء قبل نظريات النقد العربي في الإسلام أو بعدها.
وقد احتفظ التراث الشعري العربي بالكثير من الشواهد الدالة على سلطة الموقف اللغوي على الشاعر، منها: انتقاد النابغة الذبياني حسان بن ثابت في قوله:
لنا الجفنات الغُر يلمعن بالضحى
وأسيافنا يقطرن من نجدة دما
وكان نقده على حسان استخدامه «جفنات بدلا من جفن» «ويلمعن بدلا من يبرقن».
أو قول المتلمس:
وقد اتناسى الهم عند احتضاره
بناجٍ عليه الصيعرية مكدم
وقد عاب طرفة بن العبد لفظة «الصيعرية» وأطلق عبارته الشهيرة «قد استنوق الجمل» ولعلنا لا نستغرب اللفظة لو تم ارتباطها بمقام دلالتها وبحالة الشاعر وليس بسلطة الموقف اللغوي للمتلقي وموروثه اللغوي.
وهذا النقد يتحكم فيه سلطة «الموقف اللغوي المألوف أو المتعارف» عند الجماعة، عند إنشاء الموقف اللغوي وقصديته سواء الفخر أو المدح أو غيرهما من الأغراض، الذي أصبح حقلها اللغوي والدلالي سلطة في ذاتها مفروضة على لغة الشاعر، وهنا نعود إلى تعريف الآمدي بأن الخطاب «اللفظ المتواضع عليه».
فالنقد اللغوي ينصر سلطة الموقف اللغوي للمتلقي وعاداته اللغوية على «الإستراتيجية الدلالية للغة الشاعر» وفصلها عن السياق؛ فاختيار الشاعر للفظة معينة هي تعبير للدلالة ذات قصدية لحالته النفسية أو الفكرية.
وعند ابن سيناء قول لعلنا نعرضه في هذا المقال فهو يرى «أن اللفظ بنفسه ليس بدلالة؛ إنما الدلالة هي بإرادة اللافظ»؛ وبلا شك فهو قول مستوحى من روح نظرية النظم للجرجاني.
فاللغة في الشعر ليست بالضرورة أن تتصف «بصدق المعنى الحرفي أو صدق الدلالة الواقعية» لأن تشكيل دلالة لغة الشاعر مرتبطة بظرفياته المختلفة وتحقيق المفاجأة الإبداعية.
لكن النقاد العرب قديما سلبوا حق المفاجأة الإبداعية من الخطاب الشعري؛ باعتبارها لا تخضع لمقاييس الصدق، وكان ابن طباطبا أول من أظهر مصطلح الصدق والكذب كقضية نقدية رغم وجود آثارها عند ابن قتيبة والجاحظ.
وقد قدم في كتابه «عيار الشعر» مقاييس لصدق المعنى وصدق اللفظ وصدق التشبيه، وطلب الشعراء بالسير عليها، وهذه المقاييس هي حاصل القول اللغوي للمتكلم بصرف النظر عن صفته كمصدر للتقويم؛ كمتلقٍ أو ناقد أو عالم لغة، أو موروث لغوي.
وهو ما أوقع الخطاب الشعري فيما بعد في فخ الصنعة الشعرية، والاهتمام بإرضاء الموقف اللغوي للمتلقي وشروطه، حتى جاء زمان سقط الخطاب الشعري في ظلمات التخلف.
ولعل أبا تمام كان الشاعر الأول الذي جهر برفضه لسلطة الموقف اللغوي للمتكلم في توجيه خطابه شعري من خلال حكايته الشهيرة؛ عندما قيل له:
«لماذا تقول مالا يُفهم» فرد و«لِم لا تفهم ما يقال».
ولعل هذا الرفض هو ما أضمره المتنبي في قوله:
أنام ملء جفوني عن شواردها
ويسهر الخلق جراها ويختصم
إقرأ المزيد