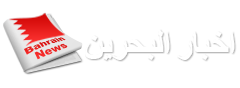إيلاف - 11/23/2025 5:10:03 AM - GMT (+3 )

للتواصل أدوار متعددة ومتعاظمة في المنظمات، فهو نافذتها للعالم الخارجي ويُشكل سمعتها، ومن يقود اتصالها الداخلي ويعزّز ثقافتها المؤسسية، ورغم أهمية تلك الأدوار لا تزال بعض المنظمات مترددة في من يجب أن يقود وظيفة التواصل؟ هل هو الرئيس التنفيذي بحكم أنه صوت المؤسسة وواجهتها؟ أم مسؤول التواصل المحترف، المحمّل بالخبرة والمنهج والأدوات؟
هذا التحدي ليس ترفاً، بل قضية استراتيجية تؤثر على استقرار المنظمات وصورتها، لأن التواصل ليس نشاطًا تكميليًا يُدار على الهامش، بل ركن أصيل من بنية اتخاذ القرار المؤسسي.
يكمُن أصل الخلاف في طبيعة التواصل نفسه، لأنه وظيفة تمسّ كل شيء داخل المنظمة وخارجها، من القرارات التنفيذية إلى ثقافة العاملين، إلى العلاقة مع الجمهور والإعلام، ويرى كل طرف أنه الأقرب منطقيًا لقيادته، فالرئيس التنفيذي هو صاحب صلاحية القرارات، وهو من يُمثل المنظمة أمام الجميع، فيجب أن يكون التواصل امتدادًا مباشرًا له، بينما يرى مسؤول التواصل، أن التواصل علم ومهنة، ويحتاج معرفة متخصصة، تحليلًا للسياق، إدارة رسائل، ورؤية استراتيجية ـ ثم صياغة وتوقيت يتطلب خبرة متخصصة، وهو ما يتحوّل في منظمات من اختلاف وجهات نظر إلى صراع صلاحيات.
هناك ثلاث مدارس رئيسة، الأولى: مدرسة "القيادة المركزية" والتي تنظُر إلى التواصل كامتداد مباشر للرئيس التنفيذي، كل الرسائل، الحملات، والأزمات تُدار من مكتب الرئيس، بينما يكون دور فريق التواصل تنفيذيًا فقط: كتابة، تنسيق، نشر، وليس صنع قرار! ولهذه المدرسة مميزات منها: توحيد الرسالة، سرعة اتخاذ القرار، صلابة إدارة الأزمات، بينما عيوبها: غياب خبرة إدارة التواصل، تركيز الرسائل على رؤية فرد "توجه غريزي" لا على رؤية مؤسسة، احتمال تضارب المصالح وانحياز الخطاب، لحماية القيادة لا حماية المنظمة، وغالباً ما تكون منتشرة في الشركات العائلية والجهات الحكومية، ومن أمثلتها ما يفعله "إيلون ماسك" في "تسلا"، الذي يقود وظيفة التواصل بنفسه، تغريدات، تصريحات، ردود مباشرة، والنتيجة أحيانًا عبقرية، وأحيانًا كارثية! وقد هبطت قيمة السهم أكثر من مرة بسبب تغريدة غير محسوبة، وهذا مثال جلي أن القيادة المركزية للاتصال تحمل مخاطر مرتفعة مع غياب المختصين.
المدرسة الثانية: مدرسة "قيادة الخبراء"، حيث يكون مسؤول التواصل هو المسؤول التنفيذي الأول عن وظيفته، ويجلس ضمن طاولة القيادة، ويُحدد الرئيس التنفيذي التوجه العام، لكن التفاصيل التنفيذية للتواصل وإدارته كلها بيد المتخصصين، ومن مميزاتها: المهنية والاحترافية، القدرة على تخطيط استراتيجي طويل الأمد، بناء منظومة تواصل داخلي شامل، بينما عيوبها: احتمالية ضعف التناغم إذا لم تكن العلاقة بين مسؤول التواصل والرئيس التنفيذي وثيقة، بطء قرار إدارة الأزمات، لكنها هي الأكثر انتشاراً في الشركات الكبرى، ومن أمثلتها ما حدث خلال أزمة التمييز العنصري في "ستاربكس" عام 2018م، حيث كان القرار التاريخي لمسؤول التواصل هو من الذي أنقذ الشركة، حينما إغلاق المتاجر ليوم كامل للتدريب! بينما لو كانت القيادة مركزية من الرئيس التنفيذي وحده، فقد تكون الرسائل دفاعية أكثر واعتذارية أقل.
المدرسة الثالثة: مدرسة "التشارك"، وهي الأكثر تطورًا ونضجًا، والتي أميل لها، حيث يقود فيها الرئيس التنفيذي "الاتجاه العام" ويمثل صوت المؤسسة، بينما يقود مسؤول التواصل "المنهج والاستراتيجية والتنفيذ"، وهي علاقة قائمة على الثقة والوضوح والمهنية، ومميزاتها: توازن بين السلطة والخبرة، القدرة على بناء رسائل استراتيجية متماسكة، تؤهل المنظمة لنجاح طويل المدى، وغالباً ما تكون عيوبها محدودة إذا كانت الحوكمة واضحة.
لكن حتى ينجح هذا النموذج، لابد أن تكون العلاقة بين الرئيس التنفيذي ومسؤول التواصل "شراكة استراتيجية"، وأن يحصل مسؤول التواصل على مقعد في طاولة القيادة، مع اجتماعات أسبوعية ودورية، ووضوح في مصفوفة الصلاحيات، عبر سياسات واضحة، لمن يقرر ومن يوافق، ومن يدير الأزمة، ومن يصرح؟
الصراع ليس بين رئيس تنفيذي ومسؤول متخصص، بل صراعٌ بين منهجية تؤمن بالخبرة والمهنية، وأخرى تؤمن بالسلطة والقرار المركزي، والتواصل الفعال لن ينجح إلا بقيادة مشتركة محوكمة، تضع مصلحة المنظمة قبل كل شيء.
إقرأ المزيد